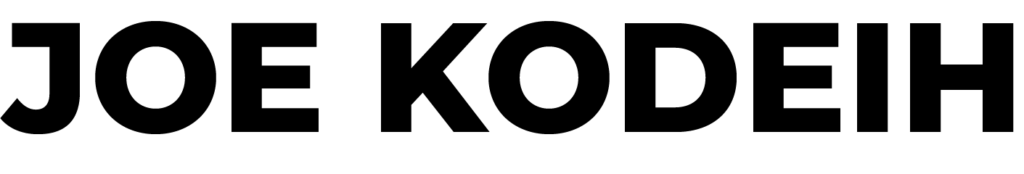
إلى حدا بالمسرح

بين مطرقة التمثيل وسندان الكتابة، يصقل رالف.س معتوق مواهب عدة، تصب كلها في العرض المسرحي.
يطغي جو قاتم على مسرحياته، يُذكر بمسرح المخرج البولندي ليجيك مادجيك.
يسرح قلم رالف.س معتوق بين سراديب الطفولة المهمشة وصدمات الحياة المتكررة، مستنداً على عناصر درامية ينبشها من مدافن ماضيه.
يُذكر هذا المسرح بنمط المخرج البريطاني ألفرد هيتشكوك، الذي عندما سئل هذا الأخير لماذا لا يُخرج فيلماً مفرحاً، أجاب: “أتتصورون جثة في عربة سندريلا؟”
الحبكات التي يعتمدها معتوق في كتاباته مصاغة بشكل متقن، على الرغم من أنها تتطلب المزيد من الجرأة، حيث لا يجب أن يخاف هذا الكاتب في الغوص في سيكولوجيا الشخصيات ودسامة العبث في الحوارات.
موهبته واضحة كما هواجسه، لكن يجب أن يتعامل معها بدقة أكبر، أن يواجه وساوسه كما واجه غيلغاميش فكرة الموت بعد فقدان صديقه أنكيدو، أن يتقبل بأن تسبح جثة أوفيليا في مياه ذكرياته وأن يُذبح أستياناكس إبن هيكتور أمام أسوار طروادة، لتولد معه تراجيديا جديدة تعطي أملاً في ظلمة المسرح.
إن كتابات معتوق قد تكون بداية نهضة جديدة، فمضمونها يشبه العلاج النفسي من خلال الخشبة، لعل صرخته النابعة من هاجس الموت تلقى آذان صاغية.
نشهد اليوم الكثير من المواهب الشابة في المسرح اللبناني، على الرغم من أنها لا تزال خجولة، تتأرجح على درج هش ورفيع، يكسر كل قوانين الهندسة المعمارية والأدبية، كالذي اعتمده معتوق في عروض مسرحيته الأخيرة “إلى حدا ما”.
يجب على هذا الجيل، جيل رالف.س معتوق، أن يغوص أكثر في الكتابات عن المسرح، أن يكتشف كتَّاب ومخرجين لبنانيين سابقين عبَّدوا لهم الطريق، وأن يعطوا الوقت الكافي للحياة كي تصب طينها في قوالب موهبتهم.
كثرة الإنتاج الممول من جهات مشبوهة كالمنظمات غير الحكومية التي تنهش ثقافتنا ومفاهيمنا والثرثرة الأدبية المعتمدة في الورش المسرحية المبرمجة لا تعني أبداً النجاح، بل هي باتت “إلى ما حدا”، كفقش الأمواج على صخور شواطئنا، تحدث ضجيجاً وفقاقيع زبد، ثم تندثر.
على شباب المسرح أن يختاروا بين أن يكونوا نشطاء أو مسرحيين، وإذا اختاروا الإثنين سويةً، فلا يجب أن يقعوا ضحية أجندات سياسية/اجتماعية مدبرة.
لم يقع رالف.س معتوق في فخ هذه المنظمات ودعم السفارات المشبوه، فما زال مسرحه نظيفاً، متصالحاً مع البيئة التي انطلق منها، غير طامح لتأشيرة من هنا أو مساعدة مالية من هناك.
انكب الكثيرون على مواضيع كتفجير المرفأ أو مجازر غزة كي يستثمروا هذه الأحداث المؤلمة في أعمالهم، لكنهم لم يعطوا الوقت الكافي، كي يحفر الزمن في الذاكرة بعد أن نهش اللحم.